الاستثمارات الأجنبية في سوريا.. هيمنة مغّلفة أم فرصة للنهوض؟
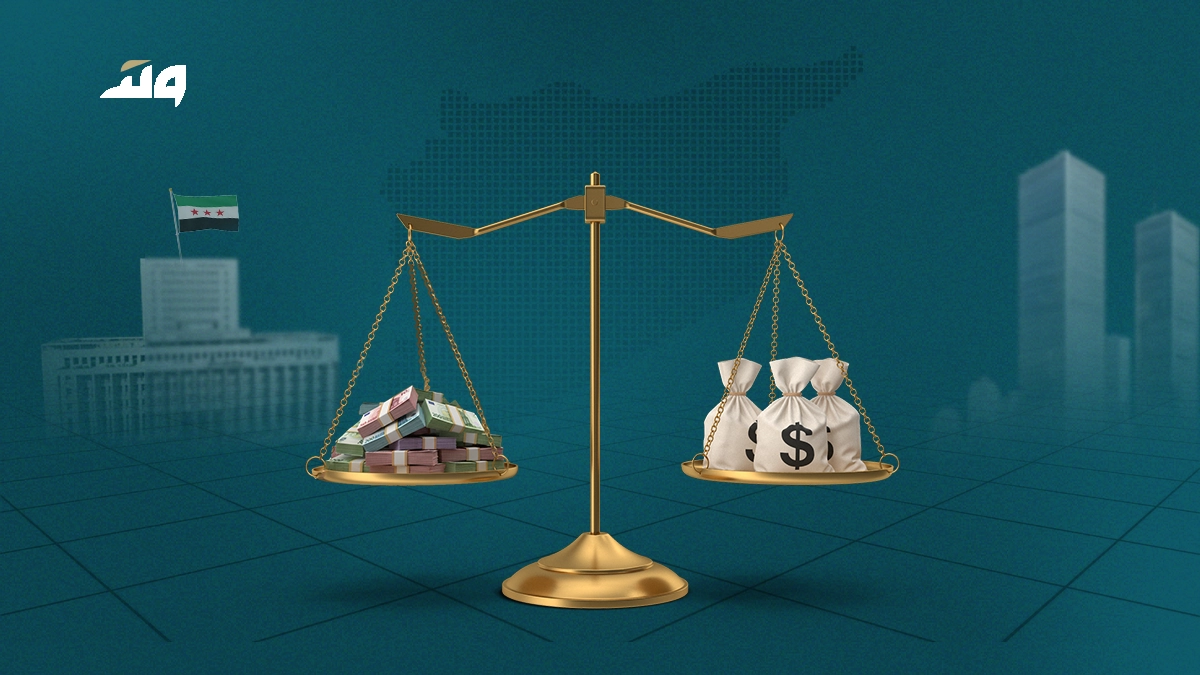
الوقت اللازم للقراءة:
9 minsيهيمن في الخطاب العام في سوريا الحديث عن فتح باب الاستثمارات الخارجيّة بوصفها حلاً سحرياً، لكن الأهم هو كيف يمكن جعلها خادمة لخطة وطنيّة لا حاكمة لها، إذ تلوح منافع واضحة حين تملؤ هذه الاستثمارات فجوة رأس المال، وتَجرّ خبراتٍ وتقنياتٍ وتفتح أسواقاً جديدة وتُنشِّط التشغيل، بينما تلوح في المقابل مخاطرها حين تُقيّد السّوق أو تُزاحم المُنتَج المحلّيّ أو تَستنزف الموارد أو تُنشئ ارتباطات طويلة تُضعف القرار الاقتصاديّ المحلي، ويبقى المحور الرئيسي هو كيف نُميِّز ما ينفع ممّا يَضر البلاد، وكيف نُحدد القطاعات الأَولى بالانفتاح والشروط الّتي تجعل رأس المال الوافد إضافة لا عبئاً.
أين تنتهي منفعة الاستثمارات الأجنبيّة وأين يبدأ ضررُها على السوق المحلّي؟
تمنح الاستثمارات الخارجيّة البلدانَ الخارجة من الحروب أو الركود العميق جرعة سيولة وتمويلاً للتقنية والخبرة الإداريّة، وتفتح أسواقاً جديدةً أمام صادرات جامدة غير مستثمرة فيها بعد.
في الحالة السوريّة تعتبر الحاجة إلى رأسمال لإعادة الإعمار والبنى التحتية المدمرة مثل قطاعات الطاقّة والنقل والمياه واضحةً، وذلك لكلفتها التي قدرّها البنك الدولي في تقريره الأخير 216 مليار دولار والذي يمكن اعتباره أقل تقدير وفي تقديرات أخرى تصل إلى 800 مليار دولار.
لكنَّ المنفعة لا تظل ممتدّةً إلى ما لا نهاية، إذ تنتهي حين تتحوّل الاستثمارات إلى تملّك مُسيطر على موارد نادرة، أو على أسواق أحاديّة لا بدائل لها، وعندها يظهر ضررٌ مادي ومؤسّسي ينعكس على تنافسيّة الشركات المحليّة، وعلى استقرار سعر الصرف وعلى قدرة الدولة على صنع السياسة العامّة.
يتجسد أول الضرر بإزاحة منافسين محلّيين حين تدخل شركات كبرى بقدرات مادية وتكنلوجية كبيرة، وتتمتع بإعفاءات واسعة، فتبيع بأقلّ من كلفة المنتج المحلّي لفترة كافية، ثم تُخرجه من السوق، وبعدها تُفكِّك سلاسلَ التوريد المحليّة وتحوّل البلد إلى نقطة تجميع واستهلاك.
ويتجلى ثاني الضرر في تسليع الموارد المشتركة مثل الفوسفات والمياه والنفط حيث تنتقل الريوع إلى الخارج عبر التحويل بالعملات الصعبة، ما يضيّق على المصرف المركزي وتضغط على العملة الوطنيّة.
أمّا ثالث الضرر فهو ترسيخ نمط الاستيراد، إذ تفضّل بعض الاستثمارات الاستيراد الكامل، ثمَّ إعادةَ التعبئة أو التجميع السطحيّ بما يوسّع العجز التجاري، ويؤخّر بناء قاعدة صناعيّة حقيقيّة.
ورابع الضرر يتعلّق بالسيادة، حين تُقيِّد العقود الحصريّة والطويلة أيدي الدولة وتمنح المستثمر حقول بنى تحتيّة حيويّة للفترات طويلة، فيصير القرار العام رهينة شروط تعاقديّة صلبة.
تظلّ المنفعة قائمة متى رُبطت الحوافز بشروط قابلة للقياس، مثل نسبة توظيف محلي وبرامج تدريب ونقل تقانة عالية؛ حيث تتوافق هذه المقاربة مع “إطار سياسات الاستثمار من أجل التنمية المستدامة” (الأونكتاد، 2015) الذي يدعو إلى جيل جديد من سياسات الاستثمار، يربط الحوافز بأهداف قابلة للقياس، ويؤكّد على شفافية العقود والمكوّن المحلّي ومنع تركز السوق، بجانب نشر العقود الكبيرة على الملأ وإخضاعها لمراجعات دوريّة كلَّ خمس سنوات، مع حقّ التعديلِ المعقول وفق مصالح الدولة والمستثمر.
إنَّ السوقَ السوريّةَ قادرة على مزيج متوازن من استثمارات أجنبية تشغّل رأس المال، وتضيف معرفة وتفتح التصدير، وذلك عبر حماية ذكيّة مؤقّتة، تُتيح للشركات المحليّة أن تقف على قدميها، وكلّما كان العقد أوضح والمنافسة أعدل والقضاء أسرع، كانت منفعة الاستثمار أكبر وأوسع وأطول أمداً.
تجارب الدول الأُخرى التي انفتحت انفتاحاً كبيراً على الاستثمارات الخارجيّة
أظهر المغرب في التسعينات وبدايات الألفيّة أنّ الانفتاح يصبح ناجعاً حين يُبنى على سياسة محلية ومهنية صارمة. فقد استقطب مصانع للسيّارات والطيران مثل رينو (Renault) الفرنسية، وبوينج (Boeing) الأمريكية، ثمَّ لم يكتف بالتجميعِ، بل نسج شبكة مُورّدين محلّيّين على مستويات عدّة فتصاعدت القيمة المضافة وتوسّعت قدرات الهندسة وخدمات ما بعد البيع، والدرس أنّ شرط المكوّن المحلّيّ والتدريبِ لا يقلّ أهميّةً عن الإعفاءات أو الأراضي.
وقدّمت فيتنام درساً ثانياً حين ربطت الانفتاح بمسارات تصعيد صناعي متدرّج، بدأت بالخياطة البسيطة ثمَّ انتقلت إلى الإلكترونيات واكتسبت خبرة تصميميّة وخدمات لوجستيّة متخصّصة، فالمعيار لم يعد حجم الصادرات وحده، بل عمق المحتوى المحلّيّ ومستوى التقنية المضافة، وهذا ما تحتاجُه سوريا كي تفلتَ من فخّ التجميع السطحيّ.
وتكشف إثيوبيا جانباً آخر إذ نجحت في جذب مناطق صناعيّة للنسيج والجلود، لكن ضعف المؤسّسات وإبهام العقود جعلا جزءاً من الاستثمارات ريعيّاً، فعندما يغيب القضاء المستقلّ وشفافيّة المناقصات، تضعف الثقة، ويعمّ تسعير مفارق للواقع، ويضيع أثر الاستثمار على المهارات وفرص العمل.
وأمّا جورجيا فقد حسّنت ترتيب بيئة الأعمال بتبسيط الإجراءات، ومكافحة الفساد، وفتح السجلّات التجاريّة، لكنَّ غياب سياسة إحلال صناعيّ واضحة أبقى اعتماداً مرتفعاً على الواردات في السلع عالية القيمة، كالسيارات، والتوربينات الغازية، ومعدات الاتصالات والأدوية، والدرس أنّ تيسير الأعمال شرط لازم، إذ يحتاج إلى سياسة صناعيّة ذكيّة تحدّد القطاعات التي تُحمى مؤقّتاً، وتلك التي تُفتح للمنافسة الكاملة.
بالنسبة لسوريا فإنّ الخلاصة العمليّة هي مساران متكاملان:
- مسار أول لقطاعات جاذبة لرأس المال الأجنبيّ، بشروط نقل تقانة وتوظيف نسب عالية من العمال السوريين، وتدريب ومراجعة للعقود.
- ومسار ثانٍ لقطاعات تحمي الشركات المحليّة، وبذلك يُستفاد من رأس المال والخبرة الوافدة دون الوقوع في أي احتكار أو ارتهان خارجي.
ما البديل عن الاستثمارات الخارجية؟ وهل يمكن الاعتماد على الذات؟
هناك العديد من الطرق التي تتقاطع في مختلف النقاط والتي يجب أن يسير بها الاقتصاد بنفس الوقت وهي ما يلي:
الطريق الأوّل انتقاء للواردات، أي تُحدَّد سلع يمكن تصنيعها محلّيّاً بكلفة قريبة من كلفة المستورد، مثل الأدوية الأساسيّة وموادّ البناء ومدخلات الزراعة. ثم تُمنَح هذه الصناعات حماية مؤقّتة ودعماً تمويليّاً، مع أولويّة في مشتريات القطاع العام. وتُخفَّض الحماية تدريجيّاً وفق مراجعة سنويّة بمؤشّرات واضحة للجودة والسعر ونسبة الاعتماد على الاستيراد، بحيث تكون هذه السياسة مرحلة انتقال نحو منافسةٍ كاملة، لا امتيازاً دائماً.
والطريق الثاني عبر تجميع الطاقة المتجدّدة والغذاء في منظومة واحدة تُحوِّل الشمس والرياح ومخلّفات الزراعة إلى كهرباء وغاز حيويّ وأسمدة عضويّةٍ، فتزيد إنتاجيّة الأرض من دون فواتير مرتفعة للعملات الصعبة. وبذلك يتراجع العبء على الميزان التجاري، ويزداد أمن الطاقة، وتُنشأ وظائف محلّيّة متخصّصة في الصيانة والتشغيل.
الطريق الثالث يرتكز على صناعة البناء والإعمار بمكوّنات جاهزة مثل خرسانة مسبقة الصنع وعوازل حراريّة ومواد أخرى بكميات كبيرة، بحيث يوضع معاييرَ واضحة ومنصّة مشتريات رقميّة شفافة تمنع التلاعب، وبذلك تصنع قاعدة إنتاجيّة لتصبح ميزة تصديريّة خلال بضع سنوات، وتسرّع الإعمارَ المحلي وتخلق فرص محلّيّة.
الطريق الرابع يمر عبر تحرير طاقات المغتربين من خلال صندوق الاستثمار بشكل مباشر، ويُمنح المستثمر قنوات شفّافة لتحويل الأرباح، مع حوافز محدّدة الأجل لقطاعات التقانة والخدمات عالية القيمة مثل التكنولوجيا، علاوة على أن المغتربين يملكون شبكة زبائن ومعرفة بالسوق العالميّ يصعب استيرادها بغيرهم.
والطريق الخامس يمر عبر تحسين حكم القانون بإنشاء محاكم أعمال متخصّصة بالعقود تُسرّع الفصل في النزاعات، فكلّ يوم يُختصر في التقاضي يُخفِّض كلفة رأس المال، ويزيد رغبة المستثمر المحلّيّ قبل الأجنبيّ.
والطريق السادس يمر عبر رقمنة الجباية والمشتريات العامّة بمنصّات مفتوحة تُنشر عليها الدعوات والنتائج، وتُحفظ فيها وثائق التعاقد، وهذا يخفض كلفة الدولة ويغلق ثغرات التسعير الوهميّ.
بهذه الطرقِ المتكاملة يُبنى اقتصاد يقوّم نفسَه بنفسه، ثمَّ يكمّله استثمار أجنبيّ منتقى بعناية كي يخدم رؤية صناعيّة مدروسة، ويعمّق القدرةَ المحلّيّة لا أن يقودَها ويستبدّ بها.
مواطن خطأ وصواب الدولة حول الاستثمارات الخارجية
تُصيب الحكومة حين تعترف بالحاجة إلى رأسمال لإعادة الإعمار وحين تدفع بتبسيط الإجراءات ورقمنتها، لأنّ ذلك يقلّل الاحتكاك الإداري ويُسرّع إطلاقَ المشاريعِ، وتُصيب كذلك حين تُعلن أولويّاتٍ الاستثمار بشكل واضح قطاعياً في الطاقةِ والنقل والمياه فتوجّه المستثمرينَ وتُخفّض من حالة عدم اليقين.
وتخطئ الحكومة حين تغلب الوعود الكبيرة على الخطط المُحكَمة وحين تُذكر أرقام ضخمة بلا مشاريع مسمّاة، ولا جداول زمنيّة محدّدة، ولا معايير قياس منشورة، وتخطئ حين تركن إلى الإعفاءات الضريبيّة والأراضي المخفّضة، وتُهمِل قوّة المنافسةِ العادلة والقضاء المستقلّ والمناقصات الشفّافة.
وتتراكم الأخطاء حين تُوقّع عقوداً لا تتضمّن شروط توظيف السوريين ونقل التقانة وتدريب وتوطين المعرفة، ويزداد الخلل حين تتداخل الصلاحيّات بين الجهات فيطول زمن الترخيص ويُفتح باب الاجتهاد غير المنضبط.
والتصحيح يتطلّبُ كتاباً أبيض سنويّاً يحصي الاستثمارات المُعتمدة، ويعرض مؤشّرات الأداء، وفرص العمل، ومؤشّرات نقل التقانة، وكذلك إنشاء نافذة تحكيم تختصّ بمنازعات الاستثمار الدولي كي لا تتحوّل المنازعات إلى سلاح ابتزاز. وبهذا الميزان يصبح الخطاب الحكوميّ أكثرَ مصداقيّة ويغدو الاستثمار الأجنبيّ جزءاً من سياسة صناعيّة مُحكمة لا عنواناً دعائيّاً وترويجياً.
التفصيل الشرعيّ لفكرة الاستثمارات الأجنبيّة
الأصل في المعاملات الإباحة ما لم تتحقّق موانع الربا ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا﴾ [البقرة ٢٧٥] والظلم والغرر الفاحش والضررِ العام والالتزام بالعقود ﴿يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودِ﴾ [المائدة ١]، والإنصاف ﴿وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ [الأعراف ٨٥]، وحماية حقوق العمال ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء ٥٨].
وقد جرى عمل الفقه الاقتصاديّ المعاصر على تفضيل صيغ المشاركة والمضاربة والإجارة المنتهيةِ بالتمليك في مشاريع البنى التحتيّة، لأنّ المشاركةَ تُوزِّع المخاطر وتربط الربح بالأداء الحقيقيّ بينما القرض الربويّ يحمّل المجتمع كلفةً ثابتةً ولو خسر المشروع.
ومن مقتضى تقليلِ الغرر أن تُحدَّد الالتزامات الفنيّة والزمنيّة وأن تُوضع آليّات عادلة للفسخ والتسوية إذا أخلَّ أحد الطرفينَ، ومن مقتضى دفع الضرر العامِّ أن تُصان البيئة والموارد المشتركة، وأن تُمنَع الاحتكارات التي ترفع السعر على الناس، وبناءً عليه تُنظَّم الملكيّة في المرافق الحيويّة بسقوف واضحة، ويُقدَّم المحتوى المحلّيّ ونقل التقانة والتدريب شرطاً للحوافز، كما يُنشأ صندوق تعويض بيئي يُموَّل بنسبة صغيرة من إيرادات المشاريع الاستخراجيّة كي يتحمّل الملوِّث جزءاً من الكلفة.
هذه الضوابطُ تجعل الاستثمار الأجنبيّ مفيداً اجتماعياً متى التزمَ بالعقود المشروعة وبالشفافيّة، وكذلك درء المفاسد الواضحة، وتمنح المجتمع قدرة على اختيار ما ينفعُه وتعديل مساره إن ظهرت أضرار لم تكنْ في الحسبان.
الخاتمة
بالعموم، الانفتاح الاقتصاديّ أداة لا غاية، ينجح حين يُضبَط بشروط واضحة للمنافسة العادلة ولنقلِ التقانة وتعميق المكوّن المحلّيّ ومراجعة العقود دوريّاً، ويؤولُ إلى ضرر حين يُطلَق بلا حوكمة ولا ميزان يقيّد الامتيازات بالمقابل التنمويّ، والسبيل الأمثل لسوريا أن تبني قدراتها من الداخل عبر إحلال انتقائيّ للواردات وطاقة وغذاء متّصلين وصناعة إعمار ومغتربين مُنظّمين وقضاء سريعٍ ومشتريات رقميّة، ثمّ تنتقي من الاستثمارِ الأجنبيّ ما يخدم خطّتَها الصناعيّة ويزيد قيمتَها المضافةَ لا ريْعَها، وبهذا تتكوّن بيئة اقتصاديّة مُتوازنة قادرة على التعافي والنموّ المستدام دون ارتهانٍ ولا احتكارٍ.

